




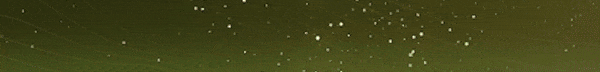
















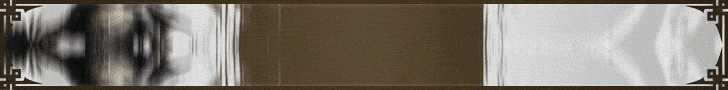










| بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود [ هذا القسم مخصص لمختلف المواضيع البعيدة كليا عن مجال الألعاب ] |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 | ||||||||||
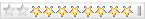
|
 اعزائى الاعضاء ، اقدم لكم اليوم نقلا عن الدكتور الكبير "جمال الغيطانى" ، احدى درر الفن الاسلامى فى مصر ، ورحلته داخلها ، فاذا كنت من عشاق التراث ، فلقد وجدت كنزا ، اما اذا كنت من اصحاب البال القصير ، وملكش مخ تقرا يعنى ^^ ، فصدقنى الموضوع مش هيعجبك ، وارجوكم بلاش ردود الموضوع طويل اوى والحاجات دى ، مرورك افضل بالنسبالى ،وانا اكاد اجزم ان الموضوع هيترك فاضى ^^ عالموم اتفضلوا الموضوع الشيق مع تمنياتى بالاستمتاع...   غموق كلمة تبزغ من أعماقى إلى سطح وعيى عندما أقترب من ميدان القلعة، حيث تطل عليه مآذن السلطان حسن والرفاعى والمحمودية وأمير آخور ومن أعلى القلعة مسجد محمد على. غموق، لأننى أدخل إلى مكان لا أعرف له مثيلاً فى العالم، تبدو فيه كثافة الزمن فى أقصى حالاتها، غموق فى جميع أوقات النهار، سواء جئته صبحاً أو ظهراً أو عصراً، حيث تبلغ تلك الكثافة أقصى حالاتها، كأننى فارقت وقتى إلى زمن آخر لا يمكننى تحديده بالضبط، هكذا الزمن لا يمكن تحديد أوله ونهايته، فقط يتوهم الإنسان علامات، كل بناء مطل يضفى قدراً من العتاقة، أما السلطان حسن، حيث المدرسة والمسجد والهيبة الرقيقة فهو مركز المكان وحوله تدور العمارات الأخرى، إنه البؤرة والمنطلق فى ميدان القلعة، من قبل ميدان الرميلة، ميدان قرة ميدان أى الميدان الأسود، حتى الخمسينيات كان يوجد سجن مجاور للقلعة اسمه «قرة ميدان»، وعلى ألسنة الناس كانت تجرى هذه الجملة. «هوديك قرة ميدان..»   تغير اسم الميدان إلى صلاح الدين بعد الثورة، والآن ميدان القلعة، أصل إليه وأبدأ رحلتى فى الزمن، إنه بوابتى التى أجتازها إلى العتاقة، إلى تفاصيل الأيام الزائلة، أقف أولاً ما بين السلطان حسن والرفاعى متطلعاً إلى القلعة وهذه الحالة من الغموق، المؤدية إلى ولوج العصور تهيمن علىّ، حتى منتصف الثمانينيات كان شارع محمد على يمر بين الصرحين، ومن قبل كان الترام يمر به، أول خط مد فى القاهرة عام ألف وثمانمائة وتسعين، أذكر عرباته المفتوحة من الجانبين، المصنوعة فى مدينة شارلروا البلچيكية، بدأ الترام نهاية القرن التاسع عشر، كان حدثاً بارزاً فى تاريخ المدينة، وقد أفرد له المؤرخ محمد سيد كيلانى دراسة فريدة عنوانها «ترام القاهرة»، درس فيها تأثير الترام الاجتماعى والثقافى على المدينة.   هذا الترام من ذكريات طفولتى.. أذكر عرباته المفتوحة من الجانبين، والدكك العريضة، انقرض مثل هذا النوع، ولو أننا أوليناه عناية لظل موجوداً حتى الآن كمعلم سياحى، رأيت فى لشبونة عاصمة البرتغال عربات ترام عتيقة الطراز مازالت تعمل فى الشوارع المنحدرة عبر المدينة صوب البحر، غير أن الترام أزيل كله من القاهرة، واستمرت العربات تتدفق فى شارع محمد على حتى أقدم أحمد قدرى رحمه الله ـ على إغلاق الطريق بين الأثرين الجليلين وقصره على المشاة، وكان ذلك من أهم الأعمال التى تمت فى المنطقة، التى أقدم على تنفيذها آخر رئيس لهيئة الآثار المصرية قبل تحويلها إلى كيان هُلامى اسمه المجلس الأعلى للآثار.   كانت القلعة منطقة نائية بالنسبة لمن يقيمون فى الجمالية، وارتبطت عندى بالموت، ربما لوجود مقابر عديدة ومناطق دفن محيطة بها من كل ناحية، مقابر باب الوزير، مقابر الإمام الشافعى، مقابر الخفير القريبة، كان الوصول إليها من خلال الحافلات العامة، أو عربات سوارس، وهو رجل يونانى أسس شركة للنقل تعتمد على عربات تجرها البغال وكان لونها أخضر، يجلس الركاب متواجهين على دكتين طوليتين وتمضى العربات فى خطوط منتظمة، كانت سهلة الحركة داخل الحوارى الضيقة والشوارع الصغيرة، وأذكر ركوبى لها مع الأسرة عند زيارة ضريح السيدة فاطمة النبوية فى الدرب الأحمر، استمرت سوارس حتى خمسينيات القرن الماضى.  تعنى كلمة «القلعة» عندى، أسرة من جهينة مسقط رأسى، الشيخ محمد حسنين أحد شيوخ الأزهر، كان رجلاً جليل الحضور، صالحاً، كريماً، وكان الوالد دائم الزيارة له، مازلت أذكر جلسته، وقفطانه المخطط، ولكن أكثر ما أثار خيالى وما علق بذاكرتى مكتبته، مجلدات تحفظ المتون المطبوعة فى القرن التاسع عشر، لابد أننى كنت دون السادسة من عمرى، لأننى أذكر تعلقى بالمجلدات «بنية اللون»، المرصوصة فوق الأرفف غير أن ذاكرتى لم يعلق بها أى عنوان، بعكس مكتبات أخرى، زرت أصحابها واحتفظ منها بعناوين كتب، فى أحد الأيام عاد الوالد حزيناً ليقول إن الشيخ محمد حسنين لقى مصرعه بعد أن حشرته عربة نقل ضخمة فى الجدار أثناء ذهابه لصلاة الفجر، فيما بعد تعرفت إلى صلاح ابنه الذى عمل فى دار الكتب، قابلته كثيراً فى قاعة المطالعة عند ترددى عليها، ثم التقيت ابنته التى عملت بإدارة المجلات التابعة لوزارة الثقافة، أما شقيقه فياض فقد فوجئت خلال حديث عابر مع أقدم أصدقائى، زميل الدراسة منذ المرحلة الإعدادية حسن بكر أنه متزوج بشقيقته.   الشيخ محمد حسنين وأسرته من أقدم الشخصيات التى عرفتها ارتباطاً بهذا المكان، للأسف لا أعرف موقع البيت بدقة الآن، ولا أسعى لمعرفة إن كان بقى فيه بعض من يمتون بصلة إلى الشيخ، الأبناء توفاهم الله، بعض الأماكن تزول رغم بقائها بالنسبة لى، لن أعرفها مرة أخرى، فكأنها انقضت تماماً، ليس الزمن بمفرده هو الذى يمر، لكنه المكان أيضاً. ها أنذا أقف فى مواجهة القلعة، مركز الحكم فى مصر منذ انهيار الدولة الفاطمية وحتى القرن التاسع عشر، منذ الدولة الأيوبية، وحتى عصر الخديو إسماعيل الذى أسس قصر عابدين، ونزل إليه ليقيم به ويمارس الحكم بين الناس، الحكم فى مصر شديد المركزية، الهرم فلسفة وليس عمارة فقط، باستمرار كان هناك مركز، وباستمرار كان المركز هو الذى تتحدد منه المصائر، القلعة من أبرز مراكز الحكم وأشدها تركيزاً، مجرد نشوب صراع بين المماليك والسلطان، فإن نقطة الحسم فيه هى الاستيلاء على هذا المكان المركز.  فى المواجهة يقوم مسجد ومدرسة السلطان حسن، السلطة الدينية فى مواجهة السلطة الزمنية، المواجهة بالعمارة لها تجليات عديدة حتى الآن، لكن ما يبهرنى فى السلطان حسن وراثته لكل الدور الثقافى المصرى، لذلك أبدأ دائماً منه.  عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المدخل لعله المكان الأشد كثافة، والأكثر تمييزاً بالنسبة لى، طفت العالم شرقاً وغرباً فلم أر مثله، ما إن أبلغ ميدان القلعة حتى يبدأ ذلك الشعور بالمنقضى يتصاعد عندى، توازيه موسيقى خفية قادمة من بعد قصى، موسيقى الترتيل الكريم، لكل مكان موسيقاه الخفية، ما بين السلطان حسن والرفاعى يبدأ صوت الشيخ محمد رفعت فى اللواح، تحديداً كلمة واحدة «بسم الله الرحمن الرحيم والعصر..». أصغى إلى سورة العصر، عادة أجىء إلى المكان فى الصباح الباكر، أحياناً الظهر، الأندر ما بين العصر والمغرب، فى كل الأوقات يفد علىّ صوت الشيخ رفعت مرتلاً سورة العصر، فكأن لهذا البناء وذاك الفراغ وقته الخاص، أدخله كلما جئت، أعبر السور الأمنى الحديدى، الذى يضع حداً للمنطقة التى تضم السلطان حسن والرفاعى، ما بينهما كان جزءاً من شارع محمد على حتى عام ثلاثة وثمانين من القرن الماضى، عندما أغلقه المرحوم أحمد قدرى بعد عملية الترميم الواسعة التى بدأها، هكذا توحد الصرحان لأول مرة فى إطار واحد، أمضى متمهلاً، السلطان حسن هو الأصل، الأصل الأكمل، ليس الرفاعى إلا صدى باهتاً له، عملية تناص فاشلة حاول إتمامها هرتس باشا المهندس النمساوى الذى أوكلت إليه فوشيار هانم والدة الخديو إسماعيل مهمة تعميم بناء مسجدها الذى اختارت له أن يواجه أجمل بناء عرفته مصر وأكثرها مهابة، إنه هرم مصر الإسلامية ولهذا أسباب عندى سوف أشرحها. أثمل متأملاً المدخل الذى يتقدم بمفرده عن امتداد المسجد ليتخذ وضعاً فيه ميل، ازورار، لم يقف أحد حتى الآن على سببه، يرجع البعض ذلك إلى تأثيرات معمارية وافدة من العمارة السلجوقية، أى من وسط آسيا، حيث نشأ المماليك، أو بتعبير أدق حيث وُلدوا، لأنهم جلبوا من هذه الأصقاع وتم بيعهم فى أسواق الرقيق إلى الأمراء والسلاطين، ليصعد بعضهم إلى مراكز الحكم، وبالطبع إلى كرسى السلطنة. تفسير آخر يقول إن هذا الازورار يمكن الجالس عند باب المدخل من رؤية القلعة، كأن السلطان يريد للقلعة ألا تغيب عن بصره، تفسير غريب لا آخذ به، عموماً، يظل السبب غامضاً، لكنى أتمنى دائماً لو عاد بى الزمن أن أحضر جلسات الإعداد لإنشاء المبنى، لتصميمه، أن أرى محمد بن بلبك الحسنى شاد العمائر وهو يعد العدة للبناء الأعظم، ماذا كان يجول بخاطره؟ أى رؤية؟ أى جرأة وقدرة على الإبداع، كيف ترسب المضمون الثقافى لمصر فى وجدانه وكيف جسده على الأرض؟، كيف جرى الإعداد قبل ضربة أول معول لحفر الأساس؟، إننى لا أرى البناء فقط، إنما أتمثل بالخيال خطوات تحققه حتى اكتماله، أحياناً أقول نتيجة رؤيتى للمكان، إن اختياره هنا ليكون رمزاً للسلطة الدينية فى مواجهة السلطة المدنية، كتلة معمارية هائلة فى مواجهة منشآت القلعة القائمة فوق صخور المقطم، لم يكن مسجد محمد على عثمانى الطراز فى مكانه، اختار محمد على موقعه حتى يهيمن به على المدينة كلها، إنه رمز السلطة الدينية والمدنية أيضاً، أحاول أن أنساه، أتخيل المكان قبل ظهوره وتسيده للأفق.  السلطان حسن فى مواجهة أسوار القاهرة.. بالتأكيد السلطان حسن أقوى حضوراً، خاصة أن الفراغ كان يحيطه من الجهات الأربع، هكذا رآه الرحالة والفرنسيون الذين جاءوا مع الحملة، هكذا يبدو فى لوحات وصف مصر، مهيباً سامقاً لا يدانيه شىء، عندما كان قائماً بمفرده فى الفراغ لم يكن لأى شىء أن يتجاوزه، لكن شوش عليه ونال منه، مسجد المحمودية القائم فى المواجهة، مسجد شيد بعد الغزو العثمانى، وأيضاً مسجد محمد على، ثم مسجد الرفاعى الذى حاول المواجهة المعمارية، لكنه بدا كالصدى الباهت المفتعل، مدرسة ومسجد السلطان حسن فى مواجهة فعلية مع القلعة خلال العصر المملوكى المستقل، كان الأمراء المتمردون على السلطان يصعدون سلم المئذنتين الأماميتين، طول كل منهما ثلاثة وثمانون متراً، أى ما يقارب تعداد مبنى طوله ثمانية وعشرون طابقاً، كانوا ينصبون المنجنيق ويقصفون القلعة بالحجارة، فى عهد السلطان برقوق ثم سد السلالم المؤدية إلى أعلى حتى لا يطلع الأمراء إلى المئذنتين ويحولوهما إلى منصة لإطلاق القذائف الحجرية، فى زمن آخر يذكر ابن إياس واقعة طريفة، إذ جاء فهلوان ـ بهلوان ـ من بلاد الحبشة، مد حبلاً بين السلطان حسن والقلعة وعبر فوق الميدان الذى ازدحم بالناس من شتى الأصناف وهم فى ذهول.   أقترب من المدخل غير أننى لا أصعد السلالم المؤدية إليه، السلالم من الناحيتين اثنتا عشرة درجة حجرية من هنا، ومثلها من هناك، لنلاحظ رمزية الأعداد، رقم الاثنتى عشرة. اثنتا عشرة ساعة نهارية. اثنتا عشرة ساعة ليلية. اثنا عشر شهراً. اثنا عشر إماما عند الشيعة، الأعداد لها مغزى، لم يوضع شىء صدفة، ومن الأرقام التى سنقابلها سبعة المقدس، الأربعة وعشرون ، ثمانية، ثلاثة، لكل موضعه ومغزاه. بدلاً من الدخول أتراجع حتى أتوقف عند بدء السلالم المؤدية إلى المدخل الغربى لمسجد الرفاعى، أتوقف وأرفع البصر لأرى المدخل فى مجمله، إنه شاهق الارتفاع، فى علوه واحد، الفراغ لا يتجزأ، لكنه بالمادة منقسم، ثمة مستطيلات لكل منها زخارفه المختلفة عن الآخر، مروجات من الزخارف الحجرية، دوائر من الزخارف المنحوتة فى الرخام، ثم مقرنصات ترتفع من تحت إلى أعلى، مدخل داخل المدخل، صف من حجارة بيضاء يعلوه آخر من حجارة سوداء، إنه نظام الأبلق الذى نراه عادة بالتبادل بين الأبيض والأحمر، لكنه هنا أبيض وأسود، كلاهما يرمز إلى ما يتجاوزه، ربما إلى الليل والنهار، إلى الحضور والغياب، إلى الوجود والأبد الأبيد، ما من لون، ما من شكل، ما من خط وليد الصدفة هنا، لذلك أقول إن هذا ليس عمارة إنه مجمع أفكار فلسفية، هكذا كل بناء مصرى صميم، لابد أن يكون فى حوار مع الكون ـ وسنرى كيف ـ ولابد أن يحتوى أفكاراً فلسفية تتجاوز الحجر والطلاء والحفر والمحفور فيه. لنصعد بالبصر.   لنتمهل، لنتأمل أرى الشمس أعلى المدخل، تماماً كما تعلو مداخل المعابد الكبرى، الكرنك، الرمسيوم، هابر، فى المعابد نرى قرص الشمس وقد بزغ منه جناحان ملونان، إنها الشمس المحلقة، الحامية، رمز الحماية والعناية ودرء المخاطر غير المرئية، رأيت رمز الحماية المصرى القديم على مدخل السلطان حسن، تلك الطاقية أو الحنية أعلى المدخل تنتهى بقرص دائرى صغير تتدلى منه خطوط تتبع منحنى التكوين، تنتهى بما يشبه أزهاراً صغيرة. دائماً أسأل نفسى بدهشة: هل يمكن هذا؟ استدعى إلى مخيلتى الشمس الإخناتونية، قرص الشمس الذى تتدلى منه الأشعة، كل خط شعاع ينتهى بيد آدمية، قرص الشمس آتون موضع عبادة إخناتون، رأى فيه رمزاً للإله الواحد، الأحد. عندما أقارن تدركنى دهشة. هل يعنى ذلك أن مصمم المدخل رأى الشمس الإخناتونية؟ ليس بالضرورة، أقول إن مصر عندما كانت تستقر وتأمن الأجنبى المستعمر، وتشعر بالراحة على جميع المستويات يبدأ مضمونها الروحى القديم فى التعبير عن نفسه من جديد، فى الظهور، سلاطين المماليك تربوا ونشأوا فى مصر، لذلك لا أعتبرهم أجانب مثل العثمانيين أو الفرنسيين أو الإنجليز، لذلك أعتبر العصر المملوكى بجزأيه، البحرى والبرجى من أزهى عصور مصر ومنه وصلت إلينا هذه العمائر الشاهقة، ويكفى أن نعلم الكارثة التى ألحقها سليم الأول بمصر عندما دخلها وأبطل منها ثلاثة وخمسين فناً، تقل الصناع والمبدعين إلى الأستانة، أى أنه نهب حضارة كاملة، لذلك انحط شأن كل شىء تحت الاحتلال العثمانى ونقص تعدادها خلال قرنين من الزمان إلى خمسة ملايين نسمة، عندما غزاها سليم الأول كان سكان مصر يقدرون بثمانية ملايين، عندما جاء نابليون بونابرت وأجرى تعداداً قدرتهم الحملة باثنين ونصف مليون إنسان.  ليس بالضرورة أن يستنسخ المبدع المصرى تراث الأجداد ورؤيتهم عبر الرؤية المباشرة، ولكن يمكن ذلك عندما تشعر الذاكرة الجمعية بالراحة وتأمن الخطر يبدأ المضمون الأصلى فى الظهور، ينفض غبار الأغراب، غزوات البدو والفرس وعصور الإهانة، لا يتوقف المصريون عن الإبداع إلا عندما يلحق الانكسار بروحهم، وهذا الانكسار غالباً ما يأتى من الخارج على أيدى أجانب، أو من الداخل على أيدى الظلمة ومصادر الفساد، عندئذ يبدع المصريون فى صمت ويرحلون فى صمت، من النادر أن نقرأ اسم مهندس صمم مسجداً، أو نقاش طلى جداراً، لذلك أتوقف بانبهار داخل المدرسة الحنفية متطلعاً إلى اسم شاد العمائر محمد بن بلبك الحسنى، هناك بعيداً عن الأنظار، داخل المدرسة الحنفية خط المهندس العبقرى اسمه على الجدار وربما تعمد هذا المكان القصى، الداخلى ليخفى نفسه ويؤمنها أيضاً، فإحدى السمات المملوكية، الهمس وصب الحقد فى أذن الحاكم ضد هذا أو ذاك، يذكرنى اسم محمد بن بلبك الحسنى بالمهندس العبقرى سنموت الذى صمم وشيد الدير البحرى للملكة عشيقته حتشبسوت، كان يكتب اسمه خلف أبواب المعبد، حتى لا يراه أحد عندما يفتح مصاريعها، وكان يكتب اسمه ويغطيه بالطلاء مرتين وثلاثاً، كما توقع نبش بعضهم قبرهم، محوا اسمه، أى أبادوه فى العالم الآخر، أحد المضامين المصرية، الاعتقاد بأن ذكر الاسم بعد رحيل صاحبه يعنى بقاءه حياً هناك، لذلك اجتهد المصرى فى أن يبقى اسمه على بناء أو بالذكر نتيجة فعل الخير والبر الحسن: أليس هذا ما نجده حتى اليوم؟ عديدة تلك العناصر القادمة من الزمن السحيق إلى العمارة المملوكية التى اكتملت فيها خصائص المصرية، الشمس المعلقة وأشعتها المتدلية، المنتهية بالأزهار، تماماً مثل الأشعة الإخناتونية ليست العنصر الوحيد.   إذن فلنر أتجه على مهل مرتقياً الاثنتى عشرة درجة من الناحية اليسرى بالنسبة للداخل هاأنذا أقف تحت المدخل الشاهق، أتأهب لعبور العتبة الرخامية بحد التجرد من حذائى، لكن مهلاً، فقط فلنتوقف أمام عنصر واحد، الزخارف عديدة، ولكننى فقط ألفت النظر إلى هذا الميداليون، إنه يحوى بعض الجوهر، الرؤية وقبصاً من السر الذى لن يفضه أحد قط. التدرج لا شىء يولد مكتملاً، لا النهر يمتلئ فجأة، ولا الطفل يأتى بالمعارف كلها، كذلك الشجر، لا يثمر بغتة، التدرج أحد قوانين الوجود والطبيعة، المصريون لاحظوا ذلك وكان مصدرهم الأول النهر، بعد طول انتظار كان الفيضان يلوح من خلال نقطة ماء سرعان ما تتدفق وتتعاظم لتصبح هديراً، هذا التدرج مفهوم أساسى مصرى تجسد فى العقيدة والبناء والفن. ها نحن أمام المدخل المهيب، نلحظ على الجدارين المتقابلين وجود ما يشبه ثمرة الكمثرى، أو قطرة الدمع، فى الزخرفة تسمى الميداليون، الأولى تقع إلى جانب الجدار ناحية الشرق، الخطوط داخلها تبدو كالهمس ولولا التدقيق ما أمكننا رؤيتها، وربما يظن البعض أن السطح خال، فى مقابلها تماماً، على الجانب الغربى ميداليون مماثل، لكن الخطوط التى تشكل الزخارف الداخلية أعمق وأوضح، بدأنا نتعرف على الملامح، الميداليون الثالث على الجدار نفسه، هنا نلاحظ أن الاكتمال يتم فى شكل دائرى، ليس خطاً مستقيماً، لو أن الوجود يمضى فى خط مستقيم لمضى إلى نقطة غير محددة فى المجهول وما عاد إلى أصله، لكن الوجود عندما يتبع شكل الدائرة فإنه يرجع إلى حيث بدأ. «ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة»  ننتقل بالبصر إلى الجانب الشرقى لكى نرى الميداليون الأخير وقد اكتملت زخارفه داخله، واتخذت شكلاً متداخلاً، لو أننا انتقلنا إلى الميداليون الأول على الجدار نفسه على خط واحد لوجدناه محواً، أى أننا لو قمنا برحلة عكسية بالبصر سنجد أننا عدنا إلى النقطة نفسها، تلك قراءتى لتلك الأشكال الأربعة، الزخرفة الإسلامية ليست فناً صامتاً، ليست أشكالاً مفرغة، إنما تضج بالمعانى، المهم أن نتوصل بها، أن نكتشفها. أتقدم من المدخل، أعبر العتبة، من الرخام الأبيض، هنا فاصل بين عالمين، الدنيوى الخارجى، حيث الضجيج والمعاملات والنزاعات والمصالحات، وهنا بداية عالم آخر فيه هدوء وتأمل، محوره الكون والإنسان، اللامحدود والمحدود. الباب خشبى من مصراعيه، دائماً يتضمن باب المسجد أجمل الزخارف، والآيات المطمئنة. «ادخلوها بسلام آمنين» أو دعاء: يا مفتح الأبواب، افتح لنا خير باب غير أن الباب الذى نراه الآن زائف، بديل للباب الأصلى الذى استولى عليه السلطان مؤيد شيخ حموى مقابل مبلغ زهيد جداً حتى لا يقال إن السلطان انتزعه بدون مقابل، نقله إلى مسجده المجاور لباب زويلة، حتى نعرف الفرق يكفى رؤية أبواب القبة ونوافذها وباب المنبر، نحاس مطعم بالذهب والفضة يغطى الخشب، لكم أتمنى عودة الباب إلى موقعه حتى يكتمل المدخل المهيب.   نقف فى الفراغ الذى يدخل الباب، إنه بناء متكامل، يخيل إلينا ألا شىء بعده، لا جزء آخر يليه، إلا أننا نلمح بداية درج إلى نظرنا إلى الشرق، درج غير مكتمل، ربما يؤدى إلى مكان ما، وقد لا يؤدى، مجرد اجتياز الباب نلج هذا التكوين القائم بذاته، فى مواجهتنا مصطبة مرتفعة، على الجدار فوقها دائرة كبيرة من زخارف منحوتة، مفرغة، تنطلق من مركز على هيئة قلب الزهرة، ثم تتفرع إلى أشكال شتى، دائماً ثمة مركز، لابد من مركز، لا ينطلق شىء إلا من مركز، هذا الكون الشاسع له مركز حتى وإن لم يستدل أحد على وجوده، وهذه الذرة الصغيرة التى لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر داخلها إلكترون، للذرة مركز وللإلكترون مركز، محير أمر المركز، يستعصى على الإدراك، لا تدركه الأفهام، لهذا يقول مولانا جلال الدين الرومى مخاطباً الإنسان الجهول «لا تبحث عن المركز أنت المركز».  فى المدخل تبدأ موسيقى البناء، لكل تكوين إيقاعاته الداخلية، لم أعرف مكاناً أو بناء فى العالم موسيقاه بهذه العذوبة، وتلك القوة مثل السلطان حسن، تعمد المصمم أن يضع هذه الدائرة فى مواجهة الداخلين، لحن قوى فى البداية يصعد فجأة، يمكن لنا أن نتبعه، أن نتقصاه إذا ما أطلنا البصر متمعنين، متفحصين، موسيقى البناء تنبع منا أيضاً، تفاوت درجات إدراكها لكن تأثيرها موجود، سار، إلى الغرب نافذة ضخم، هذا الجزء كأنه فى معبد مصرى قديم، الأسكفة العلوية، باب يؤدى إلى النافذة المطلة على الغرب، ثمة قوس دائرى أعلاه تنبثق منه أذرع حمراء، الشمس مرة أخرى غير أنها تطل من بعيد. أتطلع إلى أنصاف القباب المؤدية إلى القبة الرئيسية، الأحمر والأبيض يتبادلان مواقعهما، هناك فى العلو الشاهق ثمانى نوافذ من الزجاج الملون المعشق بالجبس، هنا تلوح موسيقى من نوع آخر، من مقام آخر يمكن أن نسميه مقام البعد أو النأى، إنها الموسيقى الهامسة غير المرتفعة لكنها توحى بالكثير. ثمانية؟ نتذكر تجليات الإله الثمانية فى مجمع الثامون فى العقيدة المصرية القديمة. نستدعى ما قرأناه عن أبواب الجنة الثمانية. عندئذ تتردد الآية الكريمة: «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية»   للأعداد مغزى ومعنى، ما يخص العلو ثمانية، ثمانى نوافذ تحت القبة، أحياناً ست عشرة كما هو الحال فى قبتى فرج بن برقوق أو قايتباى بصحراء المماليك، بالطبع يبدو الضوء الذى تحلل إلى أصوله الأولى ناعماً، قادماً من بُعد بعيد، أتوقف هنا لدقائق.. إذا انثنيت عائداً فهذا ممكن، ألم أر هذا المدخل والقبة فوقه والظلال تدثره، لكن، هذا الدرج فيه دعوة، هنا تعلو وتتضح الموسيقى مرة أخرى، موسيقى الجذب، موسيقى الدعوة. أمضى، أصعد درجتين، تليهما وقفة تحت المنور، منور شاهق بارتفاع البناء، اثنين وخمسين متراً، فى السلطان حسن أربعة متوزعة على الأركان، وظيفتها جلب تيارات الهواء إلى داخل العمارة، والضوء نهاراً، تلك هى الوظيفة المنظورة، أما الوظيفة المتضمنة، غير المنظورة، فهى إقامة العلاقة بين البناء المحدود مهما كان ضخماً، والكون الذى لا حد له، بين الأرض والسماء، بين العبد والرب، بين المخلوق والخالق، تلك فلسفة العمارة المصرية، محاورة الكون، الاحتفاظ بعلاقة به، أبواب المعابد والمقابر فى اتجاه نجم الشعرى اليمانية، المعروف بسوتيس فى اليونانية، الفتحات الخاصة بالضوء موزعة بدقة، كذلك ملاقف الهواء، إذا أراد أحد أن يعرف الفرق فليتجه إلى الرفاعى المقابل، حيث الدخول إلى الصحن مباشرة، وحيث لا صلة للكون بالبناء، كله مغطى، مصمت، لذلك يشعر من يدخله بعسر الأنفاس وارتفاع درجة الحرارة، لقد خطط هيرتى باشا المسجد وصممه استناداً إلى تراثه هو، مسترجعاً الكاتدرائيات والكنائس الضخمة فى فيينا وغيرها، لم يشغله إلا ضخامة المعمار المواجه له ومحاولة التوازى معه على الأقل إن لم يستطع تجاوزه، لم يفهم المعانى الكامنة، ولم يسمع الموسيقى السارية.  أرتقى الدرجات الخمس دهليز يؤدى إلى منحنى لكن المنعرج لا يفصح عن نفسه من هنا، إنه أضخم الدهاليز فى العمارة المصرية، كل المساجد المصرية الصميمة لابد أن يمر الإنسان بممر قبل وصوله إلى الصحن المكشوف، إنه نفس تصميم المقابر المصرية القديمة، كذلك الأهرام من الداخل الذى تدخله على أربع وتجتاز فراغه على اثنتين ثم تنحنى مرة أخرى على أربع لتلج غرفة الدفن، يا للعجب والعجوبة «كما يقول الشاعر فى الهلالية»، إنها رحلة الحياة كاملة، عرض أتم لا ينتبه إليه إلا ذوو الألباب، لذلك أعتبر الممر وكأنه المهبل المؤدى إلى الولادة، مفارقة حياة والدخول إلى حياة أخرى، الدهليز أو الممر كناية عن ميلاد، عن عبور إلى اللحظة التى يبدأ فيها المرء رحلة الحياة قبل أن ينطوى راجعاً من حيث جاء. إلى اليمين فتحة، نافذة أو باب يؤدى إلى مغسلة الأموات الجماعية التى أنشأها أمير مملوكى زمن الطاعون الكبير، الذى حصد الملايين فى العالم، وصل الأمر بالناس أنه لم يعد ثمة وقت يكفى للتغسيل، هكذا ظهرت المغاسل الجماعية، فى نهاية الجدار الشرقى للممر باب صغير يؤدى إلى نفق يقول البعض إنه يفضى إلى القلعة، معد لهروب السلطان فى حالة تعرضه لمحاولة ما، لكن ما يجعلنى لا أصدق أن الباب ظاهر جداً بما يتنافى مع فكرة أنه مهرب.   فى المواجهة باب من قضبان خشبية، مغلق. الجزء بأكمله غير مخصص للزيارة، يؤدى إلى البيمارستان، أى إلى المستشفى، فلنرجئه إلى حين. ينحنى الممر فى زاوية قائمة، أتوقف هنا، يسفر الصحن عن نفسه، جزء يلوح من الإيوان القبلى، جزء وليس «كل»، أذكر بفلسفة البناء، بموسيقاه الخفية، اللحن لا يبزغ مرة واحدة، كل شىء بقدر، لذلك أتمهل هنا وأنصح من يصحبنى أن يمشى الهوينا، أعرف بالخبرة والعلاقة التى طالت حوالى نصف قرن أين يجب أن أقف، وأين يمكن لى أن أشرع؟ ليس مهماً أن ترى، المهم كيف ترى؟ أتقدم ثلاث خطوات، أتوقف هنا رافعاً البصر إلى أعلى، متنفساً على مهل، ها هو العقد الحجرى المعلق، يلوح جزء كبير منه، لم يكتمل لنظرى بعد، بقدر ما أقترب منه، بقدر ما يقترب منى ويمنحنى، يكتمل البناء كله بالسعى، بالتقدم مادياً والسفر المعنوى غير المنظور تماماً مثل السفر فى الأنفاس وبها.  قبل نهاية الممر بخطوة أتوقف، ها هو القوس الحجرى للإيوان القبلى، الإيوان المقصد، من تلك النقطة أرى الفراغ موطأ بالحجر، القوس الحجرى المعلق إلى الفراغ، كل حجر لا يقل وزنه عن طن معلق إلى الفراغ، لا يسنده عمود أو جدار، السلطان حسن خلو تماماً من الأعمدة الحاملة، توجد بعض الأعمدة فيه كحلية، منحوتة فى الجدار مثل المدخل، ليست جزءاً أساسياً من البناء. عمارة السلطان حسن تقوم على تقابل الجدران، وحملها لبعضها وارتقائها إلى أعلى بحسابات دقيقة، هذا القوس الحجرى المعلق يفوق أى قوس فى العمارة الإسلامية، يُقال إن المهندس المصمم تعمد تجاوز القوس الحجرى لإيوان كسرى بحوالى المتر، إيوان كسرى أو سلمان بك يقع بالقرب من بغداد، وقد زرته فى السبعينيات، إيوان كسرى جد هزيل بالنسبة للإيوان القبلى للسلطان حسن، ليس مهماً طول القوس، أو زاوية انحنائه، المهم تلك الروح الكامنة وراء التصميم، البناء.  والى هنا تنتهى كلماتى التى نقلتها بشرف عن العملاق جمال الغيطانى ، ارجو لمن قرأه ان يكون قد علم ما قيمة نراثنا الحقيقى تحياتى... |
||||||||||

|
| يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|